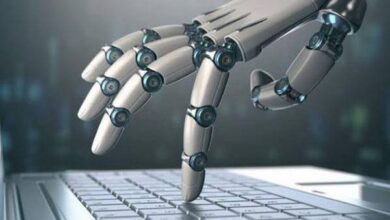مراجعة فيلم “قتلة زهرة القمر”

ريما التويجري
“غدًا سندفنُ هذا” بدأ الفيلم بهذا العنف وسينتهي بهِ! نفثَ علينا سكورسيزي بالدقائق الأولى من فيلمه شعور قبيلة الأوساج وكأنهم زهور توهّجت أوراقها، وقُبلت دعواتها؛ عندما اكتشفوا أنهم يعيشون فوق ثروة جعلتهم أغنى القبائل في 1920 ميلاديًا، بأسلوبٍ خبري مباشر تمثلت في صورة أحادية اللون تكاد تكون تسجيلية لحياة البذخ التي دفع ثمنها قبائل الأوساج دمهم، مع وجود عناوين كتابية وتجرد الصوت، وهذا ما يلجأ إليه غالبًا الأفلام من النوع الواقعي والتوثيقي، لأنه أبسط طريق وأسرع طريقة؛ لشد الانتباه، كما يقرِرُ في لاواعي المُشاهد أنه خبر مؤكَد “كالخبر التلفزيوني” قد حصل، وهذه تفاصيله. وهذا، إلى أن سمعنا موسيقى بمصفوفة أصوات نغميّة تلوح لنا ببداية القصة بوقعٍ خفيف مع صور جوية بديعة وانتقالات خفيفة سلسة، حتى اتسمت أغلب المعزوفات بالحياء، مما يحرم استمداد مشاعر “القلق، والخوف، والحزن”. فقدتُ بحَّة الناي الغليظة الطاغية، التي تحمل الآلاف من أرواح شهداء الهنود الحمر المغبونة، والتي يمكن أن أزعم أنها لو وجدت لأعطت ثقل حزن صارخ وأيقوني للمَشاهد. وعلى ذكر الثقل، أردت أن أُؤكد أن أهم جزء في أي فيلم هو أساسه وأوله، وما يميز الساعة الأولى بالمجمل الحديث الأول بين الأبطال، والذي قدمَّ تعريفًا جيدًا بالشخصيات وبما هي عليه من محدودية الإدراك والثقافة الموجودة في إرنست، ولمعان بريق التواطؤ والحقد في عين العقل المدبر خاله هايل؛ إذ عرض دربًا واضحًا لما ستؤول إليه الأمور، فهالت عليه بسرد خطي اعتيادي، ندرت فيه المفآجات، أو الألغاز السريعة، بين كل لغز وحله مدة قصيرة لينتقل للآخر، حتى يتّزن إيقاعه، وهو كذلك، متدحرج ما بين الأكشن والعنف والدراما، تجملت بجمل رنانة وصور جوهرية قدمها رجل فني – مرئي بالدرجة الأولى، وهذا ما رفع الفيلم لصروحِ قوته، سكورسيزي.
مؤامرة دراما تاريخية متسارعة؛ توالت المذابح، واحدة تلو الأخرى، طمعًا ينتشل طمعًا أكبر، وتفاصيل تجذب الأخرى حتى انتهى الفيلم بمدة مثالية. وما يحدد المدة المثالية؟ حجم المادة! لقد توارت ما بين عدة جنائز، والموت البطيء، وإلحاح هايل بالتنفيذ، وخطط سريعة، ربما فاشلة، وغدر ثم مغدور، ومحاكمة؛ كل هذه التفاصيل استحقت مدّتها. المونولوج كان حاضرًا ليشرح درامية الموقف، عوضًا عن الحوارات التي جاءت كلها بتصريح أو بتلميح لمعلومة أو هدف – رغم أن التسجيل الصوتي المعد ربما لتصحيح حديث ديكابريو عندما يتحدث لغة الأوساج في بعض المشاهد، كان من الأخطاء الواضحة لاختلاف طبقة الصوت بين الجملة والأخرى – ولن تتفاعل الخلطة الدرامية بهذا الشكل إلا بمكونها الأهم؛ ليلي غلادستون، نجحت بأداء شخصية الضحية الأكبر، الروح المعذّبة المناضلة، تعصف بها الحياة لمسارٍ لن ترى في بدايته ومتوسطه ونهايته أي خير. في حين ليوناردو دي كابريو تم تسليط الضوء على بساطته، لكنه كان الأكثر تعقيدًا، كأنه شخصين في جسد، رأيت فيه المحب والكاره، المخلص والخائن، الصادق فالكاذب، مزيج من الدهاء الاجتماعي والبلاهة الاتباعية. خُلطت في الفيلم توليفة من الأجواء الدينية، والمعتقدات المتعددة التي تمتثل إليها القبيلة، إلى جانب جماعة الكوكلوكس كلان، والماسونية الصريحة، التي ما زالت تفتعل الذنوب.
تجلّت الصور البديعة بتوازن الكادر بين اللقطة السابقة واللاحقة، بين النقطة المركزية والخلفية، وصور ملحمية من الصلوات الفجرية حتى الفواجع الليلية، حتى تمت ولادة مكتب التحقيقات الفيدرالي المتجدد، وبطلب من إدغار هوفر الذي فتح تحقيقًا خاصًا لعمليات الاختلاس الإجرامية المرتكبة بحقّهم. كما كان التكوين مثاليًا، وأعتقد أن الراحل جون ويليامز – الذي أُحيي ذكره في شارة الفيلم النهائية – كان مسؤولاً بتحرّي الدقة في اللغة والثقافة القبلية، حتى قيل إنه كان له كرسي بجانب سكورسيزي، ومما أعتبرها واجبًا أساسيًا لنجاح فيلم أشبه بالتوثيقي لمرحلة ما. كما أن مولي بطريقة إصرارها للحديث بلغتها حتى مع الأجانب الإنجليز حركة ذكية مدتني بشيء من خصال صفاتها التي تتسم بالقوة والثبات، إلا أن الترجمة التي وجدت في بعض الجمل عبارات لم تترجم – سواءً كان خطأ تحريريًا أو مقصودًا- حركة مزعجة.
عاد سكورسيزي لسرد المصير النهائي للقصة بالأسلوب الإخباري أيضًا، لكن بطريقة إبداعية تشكّلت بخبر في برنامج إذاعي في الأربعينيات يتم بثه مباشرة، وفاجأنا المخرج بظهوره لإلقاء قصة الختامية الحتمية للشخصيات، مما يدل على اهتمامه الشخصي، ودعمه لما حصل.