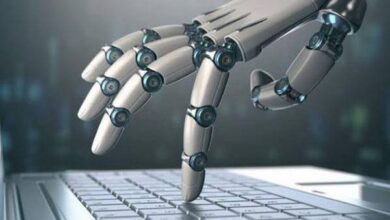في مديح اختزال الفكرة! الأفلام القصيرة

مشاعل عبدالله
تعرف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التي تعتبر مجموعة فخرية تهدف إلى تطوير فن وعلم صناعة الأفلام بشكل احترافي، الفيلم القصير بأنه أي فيلم ليس طويلاً بما يكفي ليتم تصنيفه كفيلم روائي، مما يعني أن أي فيلم يساوي 40 دقيقة فأقل يصنف كفيلم قصير. بشكل عام معظم الأفلام القصيرة لا تتجاوز مدتها 20 دقيقة.
سألت مجموعة من الأصدقاء المحبين للسينما عن تجاربهم في مشاهدة الأفلام القصيرة ورؤيتهم وتصورهم عن المخرج والمتفرج، وكانت النتيجة أن جمهور هذه النوعية من الأفلام قليل جدًا ومحدود، وربَّما هذا للاعتقاد السائد أن هذه التجربة مبهمة وغامضة لم يعتادوها. واتفق أغلبيتهم أن المخرج في هذه الأفلام يمتلك مساحة حرية أكثر للتعبير عن صوته وأفكاره، وأن المتفرج أو المشاهد لهذه النوعية من الأفلام يعتبر جمهورًا نخبويًا ومثقفًا من الطبقة المتوسطة العليا. يبدو هذا الانطباع مرتبطًا بمكان عرض الأفلام القصيرة، فالحكاية تروى بين جمهور متخصص وقاعات المهرجانات، بينما الأفلام الروائية الطويلة متاحة للجميع في صالات السينما وشاشات التلفزيون والمنصات.
في بدايات السينما كانت المدة الزمنية للأفلام قصيرة، لكن تطور صناعة السينما خلق إطارًا وضوابط للفيلم الروائي من ناحية المدة والإيقاع، ويشترك المسرح مع سينما الأفلام الروائية من ناحية الوقت الذي يقضيه المشاهد في متابعة الحكاية والحبكة.
يعتبر الفيلم القصير اعتراف المخرج الأول عن مشاعره تجاه السينما والصورة، هو رسالة الحب الأولى والموعد الأول الذي يمكنه من خلالها التعبير عن ذاته وأفكاره ورؤيته للعالم عبر قصة قصيرة مكثفة. فالفيلم القصير لا يختلف عن الفيلم الروائي من ناحية تركيب السرد الدرامي، والقصة لا بد أن تحتوي على العناصر الثلاثة المهمة، وهي البداية والمنتصف والخاتمة. لكن الفيلم القصير يسمح للمخرج بإدارة المزاج العام للفيلم أو الحكاية بشكل أكثر انضباطًا، وبالتالي التحكم بالإيقاع. ويعيب الفيلم القصير أنه لا يتيح للكاتب أو المخرج مساحة لبناء تطور واضح في الشخصية والحدث؛ لذا الفيلم القصير قد يتناول جزءًا من الحكاية أو الشخصية.
يسمح الفيلم القصير للمخرجين وكتاب السيناريو المبتدئين بدخول هذا العالم الساحر بتكاليف منخفضة مقارنة بتكلفة إنتاج فيلم درامي طويل، خصوصًا أن هذه النوعية من الأفلام لا تحتاج إلى ممثلين معروفين مما يزيد من تكلفة الإنتاج؛ فالبطولة مرتبطة بالمشاعر والتكوينات البصرية ولعبة الظلال والنور. ولا يمكن أن نغفل عنصر الصوت، فالأفلام القصيرة يحتل الصوت فيها مساحة واسعة مقارنة بالأفلام الروائية، وربما نعزو ذلك إلى أن الفيلم القصير يسمح بتكثيف المشاهد والمشاعر، فالزمن محدود والصورة متتابعة وذهن المتفرج حبيس هذا الزخم لا يمكنه الفرار.
قد تبدو مشاهدة الأفلام القصيرة للمخرجين المعروفين بمثابة خارطة طريق لمن يود التعرف على هذه الأفلام، أو الأفلام الحائزة على جوائز، خصوصًا أن بعض المنصات تخصص جزءًا من موادها لهذه الأفلام.
في الوطن العربي، تجربة محمد خان عام 1972 في فيلم «البطيخة»، تقدم لنا افتتاحية لمسيرة خان في السينما الواقعية. يأخذنا خان في فيلم لا يتجاوز 10 دقائق في رحلة موظف وأب من الطبقة المتوسطة. يقدم هذا الفيلم النموذج الأمثل على حضور الصوت كشخصية وعنصر مهم في الفيلم. يبدأ الفيلم بصوت ضربات على الآلة الكاتبة مع لقطات متتابعة لأقدام وملامح موظفين في مصلحة حكومية. يتداخل صوت الآلة مع أصوات زوجة البطل وأبنائه وطلباتهم، نشعر كمشاهدين بالضغط من خلال استخدام عقارب الساعة والمروحة ودخان السجائر، تكون البطيخة طلبًا مشتركًا بين الزوجة والابنة. نرافق الموظف في رحلته لشراء البطيخة ونشعر بتململه من خلال حمل البطيخة بطرق متنوعة، فتارة بين يديه، وتارة تحت إبطه. تبدو البطيخة في هذه المشاهد رمزية عن الحياة، فالقادم مجهول والتعامل معها ثقيل ومنهك، وهناك الكثير من التقاطعات والتعاطي مع الآخرين قبل وصوله للمنزل. نرى ملامح ركاب الباص، والضغوط الاستهلاكية من خلال لوحات الإعلانات. وأعتقد أن خان حاول التركيز على هذه النقطة، فنرى في مشهد البطل يشاهد إعلانًا لمشروب غازي مستورد، لكنه يشرب عرق السوس من بائع متجول. يدلف البطل، يحمل بطيخته إلى العمارة فيضيق الفضاء حوله، فهو ينتقل من عالم أوسع للعالم الأصغر. تنقلنا الكاميرا الجميلة لشقته في الطوابق عبر مشهد ساحر لطلوع المصعد والارتفاع والسواد. نرى طفله لا يقوى على حمل البطيخة “الحياة” فيدحرجها لأمه في المطبخ، ونتابع تقطيع الأم للبطيخة، ثم تنقلنا الكاميرا للأب مستلقيًا على السرير في غرفة النوم متجردًا من ملابسه، فهذا المكان الضيق وسط أسرته مساحة الأمان. ينتهي الفيلم باجتماع العائلة حول المائدة يأكلون البطيخة.
مخرجة سويدية قادرة على جعلك تكتشف مشاعرك من خلال الصورة والصوت ويتجلى ذلك في فيلمها Sara Broos«الوطن»، الذي يتناول تجربة مهاجرة تستعيد ذكرياتها عن دمشق وعلاقتها بعائلتها من خلال الأغاني. البرودة والجليد في بلد المهجر يناقض حديثها الدافئ، تصف بطلة الفيلم جبل قاسيون في دمشق وذكرياتها عنه بوصف عصيًا على النسيان، فهو كالأب الذي يطل ويرعى أبناءه من علو.
لصوفيا كوبولا المخرجة المشهورة، التي من أعمالها فيلم «ماري أنطونيت” تجربة جميلة في هذا المجال في الفيلم القصير «Lick the Star» الذي يركز على الجانب الاجتماعي لمجموعة من الفتيات المراهقات في المرحلة الثانوية. تمتلك صوفيا قدرة مذهلة في الفيلم لاختيار الكادرات الجميلة والمعبرة.
من تجارب الأفلام القصيرة التي تستحق الإشادة في الوطن العربي، فيلم «الببغاء» من إخراج الأردني أمجد رشيد والفلسطينية دارين سلام التي قامت بكتابه السيناريو لهذا الفيلم. يتناول الفيلم قصة عائلة يهودية مشرقية «اليهود المزراحيين» قدمت من تونس عام 1948 للاستقرار في حيفا واستولت على بيت عائلة عربية هُجرت من المدينة. تكتشف العائلة اليهودية أن العائلة نسيت ببغاء في المنزل. الببغاء هو ذاكرة العائلة الغائبة عن المشهد والمهجرة. يصور الفيلم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل مختلف بعيد عن الصور القاسية والأسلحة، أو الخطاب المباشر، يشعر المشاهد أن هذا المحتل لا ينتمي للمكان وهو دخيل عليه من خلال جدران المنزل أيضًا التي تحتوي على أثر ذاكرة المهجرين من المنزل والمدينة، ومحاولات المستوطن الحثيثة لمحو كل أثر لهم. أيضًا بلمسة ذكية من قبل صناع الفيلم نرى تفاوت المجتمع اليهودي الهجين على طاولة العشاء حينما يعزم اليهودي التونسي المشرقي، اليهودي الأشكنازي وعائلته وتبدأ المفارقات.
تستولي منصات عرض الأعمال الدرامية على حصص مشاهدة عالية، وتمتلك امتياز انخفاض التكلفة التي يتكبدها المشاهد مقابل الفائدة والتنوع، بالإضافة إلى منح المشاهدة رفاهية اختيار الوقت المناسب. هذه المنصات تحتوي على مجموعة من الأفلام القصيرة التي تستحق الاطلاع، وربَّما يجدر بنا كسعوديين دعم التجارب في هذا المجال لكتاب السيناريو والمخرجين والترويج للأفلام السعودية التي سبق لها المشاركة في المهرجانات أو في المنصات؛ حتى يكون هناك حراك وثراء في الأفكار ووجهات النظر، فالسينما فكرة تترجمها العدسة.