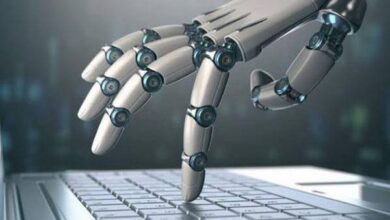وغاب القمر

قبل شهرين رأيتُ في المنام أني أطالعُ السماء وإذا بالقمر يغيب ويختفي تمامًا عن الأنظار. قمتُ فزعًا، وعلمتُ تأويلها من خلال قصة يوسف عليه السلام، وقد كانت والدتي -رحمها الله- حينها تعاني مرضًا عضالاً؛ فعلمت بالفراق قبل وقوعه.
بكيتها وهي على قيد الحياة، نعم، إنها والدتي لطيفة بنت عبدالله بن عثمان القصير من مواليد بداية عام 1360هـ ببلدة الداهنة في إقليم الوشم. قضت ما يزيد على ثمانية عقود، وكأن حياتها ليست لها؛ ترعى شؤون مَن حولها.
أذكر أني إذا جلستُ بجوارها ونظرتُ إليها وهي تغالب المرض، وتدافع الأنين، تسألني عن أحوالي وأولادي، وهي أحق أن يُسأل عنها، وتتحامل على نفسها، وربما سقطت أرضًا من المرض والضعف، ويؤتى بها تتهادى بين اثنين، وقدماها تخطان في الأرض، حتى إذا جلست وتنفست الصعداء قيل لها (كيف أنت اليوم؟) قالت (بخير، الحمد لله أحسن).
بقيتْ كذلك حتى أخذ المرض منها كل مأخذ.. فأُغمي عليها، ودخلتْ في فقد الوعي، وبقيت أسبوعًا كاملاً ربما تعي، أو يومين فقط.
وفي مستشفى الملك خالد بالرياض ضحى يوم الأربعاء، الثامن من جمادى الآخرة لهذا العام، نزلت ملائكة من السماء؛ لتقبض روحها الطاهرة، وتصعد بها إلى السماء في المستشفى؛ إذ بدأت كل مؤشرات الأجهزة الطبية الموصولة بالجسد الطيب الضعيف المنهك في النزول؛ لتبدأ الروح بالصعود. دقائق قليلة ومَن حولها يرقب، وهم بين قارئ للقرآن، ومردد الشهادتين، ثم تمتمت تلك الشفاه بصوت لا يُسمع من جسد أنهكه المرض، وروح عانت واستعانت؛ لتفيض روحها كأهون ما يكون، وينحني الرأس الساجد، وتشخص العين الدامعة؛ لتودع الدنيا وأهلها..
سلام على تلك الروح الطيبة.. سلام على هذه النفس الزكية.. سلام على هذا الجسد الصابر.
بكت عيني، وحُق لها بكاها.. وما يغني البكاء ولا العويل. بكاها فقراء كانت تتعاهدهم، توافدوا للصلاة عليها، وللعزاء، كل واحد وواحدة منهم يحمل قصة بذل يرويها بلسانه، أو بلغة عينَيْه.. نعم، لقد كانت إذا أحضرت شيئًا، أو أحضر أحدٌ لها شيئًا، لم يبت تلك الليلة عندها منه شيء؛ فالأقارب والجيران والفقراء على موعد معه.. فبالرغم من كثرة ما يكون عندها من طعام أو مال أو هدايا لا يمكن أن يبقي منها شيء، بل حتى وهي في آخر أيامها توصي (إن توفاني الله لا تتركوا أي شيء في البيت، وزِّعوا القمح والتمر، كل شيء وزِّعوه..).
لله ما هذه النفس الكريمة.. لله ما هذه اليد الباذلة.. لله ما هذا السخاء.. فليس بجديد؛ لقد نشأت رحمها الله عليه منذ نعومة أظفارها في بيت والدها وأهلها؛ إذ كانوا يُبشِّر بعضهم بعضًا بقدوم الضيف، ويتنافسون في البذل، ويتسابقون في إقراء الضيف. لقَّبهم الناس بـ(معشين الشجر)؛ ذلك أنهم أعدوا وليمة حينما رأوا من بعيد سوادًا وجهامًا، ظنوه ضيوفًا، فما لبثوا حتى تبين لهم أنه شجر أسفل الوادي؛ فلُقبوا بمعشين الشجر، ثم شبَّت وما شابت على تلك النشأة الكريمة في بيت زوجها عبدالعزيز بن عبدالله السنيدي -رحمه الله-؛ إذ كان باب بيته لا يوصد؛ يفد إليه كل أهل بلدته إذا قَدِموا إلى الرياض، لا يكادون يعرفون سواه، فضلاً عن بقية أقاربه وجيرانه وأصدقائه.. يقصده القريب والبعيد لعقود متوالية، كلما ارتحل من منزل رحل معه الكرم والبذل، من الحريق إلى الرياض إلى شقراء إلى مزرعة العب.. فأصبح هذا لأكثر من ثمانية عقود لزامًا لا ينفك عنها، وكأنه روحها.
رحمها الكريم برحمته؛ لقد قامت رحمها الله بإعداد الكثير مما يحتاج إليه تفطير الصوام المُقام في المزرعة لسنوات كثيرة، ويجتمع على الإفطار ما يزيد على مائة صائم يوميًّا، وتبدأ في الإعداد قبل رمضان بأشهر عدة، علاوة على إعداد غداء الجمعة بكل ما فيه من وجبات لسنوات كثيرة.
كانت رحمها الله تؤكد وتكرر لنا وصية والدي -رحمه الله-: (الله الله في تفطير الصوام وغداء الجمعة).
رغم هذا الجهد والإعداد كانت -رحمها الله- حريصة على صيام يومَي الاثنين والخميس، ومع ذلك لا تفطر وحدها؛ إما مع قريبة أو إحدى جاراتها. أما نوافل الصلوات فقد كانت حريصة على ذلك حتى حينما نكون في نزهة برية، تستدني سجادتها، ثم تصلي ما شاء الله لها مناجية ربها.
حينما أرى الكثير من تلك الصفات لا أستغرب تلك الجموع في المسجد، ومُصلَّى النساء والمقبرة، ومكان عزاء النساء، ومكان عزاء الرجال.. فقد اكتظت بالمعزين من جنسيات عدة، وحضر للعزاء حتى العمال، وتوافدت الوفود وهم شهود الله في أرضه، يُتوِّج هذه الشهادات شهادته -صلى الله عليه وسلم- إذ يقول: “المبطون شهيد”؛ إذ ماتت -طيب الله ثراها- بمرضٍ ببطنها. وبشارته -صلى الله عليه وسلم- لـ”مَن عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين”، وضم أصابعه. فكيف بها وقد عالت أربعًا.
لقد رحلت عن دنيا زهدت فيها، ولم تكن تجمع منها شيئًا؛ ما في يدها ليس لها؛ للأطفال والفقراء، بل العمال والعاملات..
رحم الله تلك النفس الزكية، وأنزلها مع النبيين والشهداء والصالحين، وحَسُن أولئك رفيقًا.