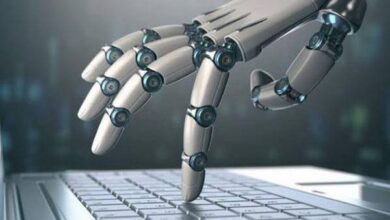الصورة الخام وما بعد الانطولوجيا

يزيد بدر
الأشياء موجودة هنا فلماذا نتلاعب بها؟
روسيليني
مقدمة:
ليس هدف المقالة تحليل ماهية الصورة وما يرتبط بها من مفاهيم مثل الحركة والزمن والضوء وغير ذلك، بل يهمنا أن نطرح سؤالين يرتبطان فيما بينهما: مدى واقعية الصورة، أي هل هي انعكاس كلي ومطلق للواقع أم هي انعكاس جزئي لا يقدم لنا الواقع كاملًا، أم أن الصورة منفصلة تمامًا عن الواقع بحيث لا توجد أي علاقة بينهما؟ ثم بعد ذلك نسأل: هل من الممكن أن توفر الأنطولوجيا مرجعًا متعاليًا للتحقق من صدق الصورة؟ سوف أتحدث بدايةً عما أسميه إرادة الواقع وهي ميل توكيدي للقبض على الواقع كما نجده في الفن الحديث والفلسفة وكذلك العلم، إلا أن المفارقة أن الواقع ذاته لا يكف عن ممانعة هذا القبض عليه، والتمسك به، مما يجعل سؤال ما الواقع؟ هو السؤال الجوهري لهذه المقالة، كما أنه الخيط الناظم لها.
إرادة الواقع:
المطلع على الفلسفات الحديثة والثورات الفنية يدُرك أن هناك ميلاً شبه عصابي للواقعية، فالواقع بالنسبة لكل برادايم هو واقع ما ترويه هذه المنظومة المعرفية، فمثلًا واقعية التحليل النفسي، وواقعية المادية الجدلية، وواقعية المثالية الألمانية… إلخ. إن سؤال ما الواقع بين هذه الواقعيات؟ لم يعد عبثًا، ولا هو مما يلقى دون مسؤولية سفسطائيي هذا العصر – فلاسفة ما بعد الحداثة – بل سؤال جدي وجب الوقوف عنده طويلًا. لكن ما يهمني هنا هو إرادة الواقع، أي ما الذي يجعل من المهم إيجاد بذرة الواقع والتشبث بها؟ من الناحية السيكولوجية يظهر أن الإنسان لديه ميل لما هو ثابت ولا يتغير، لذلك نجد ملاحظة عجيبة لفرويد في أفكار لأزمنة الحرب والموت «إن كل واحد منا في اللاشعور مقتنع بخلوده الشخصي» «فرويد، 1986، ص27». لذلك الإنسان اتخذ العديد من المفاهيم التي تحيل مباشرة لما هو ثابت ولا يتبدل كالإله والجوهر والماهية والأنا المتعالي. ومن ثم، والأهم الواقع، فهو يجد من خلاله ما يعزيه عن صيرورة الحياة. وهذه الهجمات ضد الصيرورة قديمة ومعاصرة تجدها مثلًا في أفلاطون ضد هيرقليطس، وكانط ضد هيوم، وغادامير ضد دريدا، وهكذا. وفي مجال الفن نجد ذات الثنائيات بين الواقعي والرومانسي، وفي السينما الطبيعانية والتعبيرية، وهكذا. لكن ليس من اليسير تفسير علة ذلك من خلال السيكولوجيا أو الفلسفة، لأن لكل مدرسة رأيها الذي ينطلق من أسسها. مع ذلك، نجد أن علم الأعصاب يكشف لنا ميلًا عند الإنسان للثبات وميلاً للتغير، وهو ما يذكرنا بثنائية نيتشه بين الإله أبولون وديوزنزيوس، أو غريزتي الحياة والموت عند فرويد «لذا ليس هناك نمط مستمر ناعم وثابت للتفكير، لكن هناك تداخلاً لدارات مختلفة من التغذية الراجعة يتنافس بعضها مع بعض. إن فكرة وجود أنا ككل موحد ووحيد يتخذ القرارات كلها باستمرار هو وهم خُلق من عقولنا اللاواعية» «ميتشيو كاكو، 2017، ص 50». لكن ماذا عن الناحية الفلسفية؟
الصورة الخام وما بعد الأنطولوجيا:
هنا ثمة سؤالان: هل من صورة خام؟ وإن كان هناك صورة، فهل بالضرورة تجد لها واقعًا متعاليًا حتى نتحقق منها؟ إن تاريخ الفلسفة قام على عقيدة تنص على أن كل صورة لا تكون صافية، أو بعبارة أخرى نحن لا نرى الواقع كما هو. لذلك، منذ اليونان وحتى في الحضارات الفيدية أُطلق على الواقع الذي يأتي من خلال الحواس ظلال أو مايا، وعليه نحن نملك حواسَّ تُغير من صورة الواقع ضرورةً. ولو أخذنا ندرس كل الوسائط لطال حديثنا مثل الدماغ والجسد والعالم، إلا أن النقطة المهمة هنا هي: هل هذا يعني أن هناك واقعًا مطلقًا خلف هذه الصورة غير الصافية؟ هنا علينا أن نستعين بكانط كونه يُعد بجدارة اكتمال ميتافيزيقا الصورة. فهذا الفيلسوف يرى أن للواقع مظهرين: النومين والفينومين، أو الظاهر والشيء في ذاته. إن ما هو ظاهر، أي العالم الحسي الذي يأتينا من خلال الحدس المتعالي أي الزمان والمكان، ثم يندرج تحت مقولات ملكة الفهم، بمعنى نحن لا نرى الواقع كما هو، بل من خلال ملكاتنا المتعددة كالحدس المتعالي لمقولتي الزمان والمكان ومقولات ملكة الفهم. لذلك كان لزامًا على كانط أن يخرج بهذه النتيجة وهي: أن خلف ما هو ظاهر واقعٌ مطلق لا ندركه من خلال العقل النظري. إن هذه النتيجة هي ما تُريد نقده هذه المقالة، فنحن نُريد القول بما بعد الأنطولوجيا، أي واقع بلا تعالٍ ولا مطلق، ولا شيء في ذاته. إن الصورة تظهر كما نراها، ولا يوجد خلفها مرجع متعالٍ، بل يوجد فقط اللامحسوس أو اللامرئي، بمعنى أن الظاهر وما خلفه له ذات الطبيعة دون وعد بمثال يتعالى عليه. فمثلًا نحن مجهزون بملكات للإدراك بشكل عام، إلا أن هذه الملكات لها حدود، فنحن لا نسمع خطوات النملة وهي تسير، ومع ذلك لا نقول إنها الشيء في ذاته، بل لها طبيعة الظاهر لكننا لا نُدركه؛ لأن أجسادنا محدودة بما تملك. إن الصورة تظهر بحسب تعدد وسائطها ولا تجد لها مرجعًا متعاليًا للتحقق من صحتها، وهذا ما يقودنا إلى استنتاج مهم وهو: ليس ثمة فرق بين الواقعية والمثالية في تصورها للواقع، وليس هنا فرق بين الواقعية الجديدة والتعبيرية الألمانية.
الواقعية المتعددة:
تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم في عصرنا هذا يقدمان لنا نتيجةً مهمة وهي: ليس هناك واقع مطلق، بل هنا أشكال متعددة للواقع. وهذا ما يجعل من العبث حد العملية الإبداعية في الفن من خلال مقولة الواقع، لأن العلم ذاته عَجز عن ذلك. كما أن الفلسفة لا تكف حتى اليوم عن البحث عن شبح الواقع المطلق، فما بالك بالفن الذي من المفترض ألا يرتبط خطابه بالحقيقة المتعالية؟ إن مقولة الواقع سلاح يتخذه الناقد من أجل إجهاض عمل فني ما، لذلك وجب إعادة طرح سؤال الواقع الذي نعي جيدًا أنه ليس باليسير. إن هذا السؤال طُرح سينمائيًا بجدية مع أنطونيوني في فيلمه blow-up، حيث نرى الواقع كيف يسيل من قبضة البطل، ولو كبرنا الصورة عشر مرات تطلع الصورة تبتعد عنا! إن الواقعية المتعددة فلسفة تنطلق من مكتسبات العلم الحديث وبعض الفلسفات المعاصرة مثل ما بعد الحداثة، وهي من الناحية الفنية تعد فتحًا لإبداع لا ينضب. إن سينما التعبيرية الألمانية كانت عنيفة مع مقولة الواقع، حيث لا نرى إلا أمكنة مشوهة، وأزمنة مفككة. لقد بدأ سؤال الواقعية في السينما مع لوميير وجورج ميليسس، حيث نرى الأول يصور قطارًا، ومن خلال المنظور وهندسة الأبعاد يوهم بالتصادم مما أرهب الجمهور. بينما الثاني في فيلميه «رحلة إلى القمر» و«اكتساح القطب» نشاهد عالمًا سحريًا. وهذا الإرث جعل من اللازم سؤال المخرج لذاته: أي واقع جدير بأن أعرضه وأحاكيه؟ ولأن مقولة الواقع حين تكون عنيفة في تعاليها تجعل من حركة الإبداع فقيرة، لذلك جاءت هذه المقالة لترفع كل مرجع متعالٍ للواقع، وتمهد الطريق لواقعية مادية وفي ذات الوقت سحرية وشاعرية. وقبل أن أختم أذكر أن لمقولة الواقع المطلق عنف ضد الآخر، فنحن ننبري مباشرةً ضد من لم يوافق معاييرنا بقولنا «هذا عمل غير واقعي»، بينما السؤال الأكثر عمقًا والذي يجب على الناقد تبنيه: عن أي واقع نتحدث؟
المراجع:
فرويد، أفكار لأزمنة الحرب والموت، دار الطليعة، 1986، ص 27.
كاكو، مستقبل العقل، المجلس الوطني للثقافة والفنون، 2017، ص 50.
المصدر: سوليوود