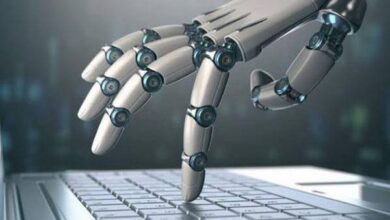عصافير الشرق في السينما

مشاعل عبدالله
استقبلت شاشات السينما في الأيام الماضية فيلم «فوي! فوي! فوي!» وأثير حوله الكثير من الجدل بداية من القصة التي تم اتهام السيناريست والمخرج عمر هلال بسرقتها، وغضب بعض المغاربة منه بسبب ذكره أن الإيطاليين يطلقون لفظ ماروكيني على العرب الذين دخلوا إيطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية.
«مستوحى من أحداث حقيقية» جملة تتوسط أفيش الفيلم، وبالنسبة لي ربما تبدو هذه الجملة هي عنصر الجذب لحضور الفيلم، بالإضافة إلى وجود نيللي كريم ومحمد فراج؛ لأن العلاقة مع المخرج والسيناريست عمر هلال مبهمة، فهذه هي تجربته السينمائية الأولى، فلا يمكن التعويل عليها.
الأفيش لا يقدم لنا لمحة إلى محتوى الفيلم فقط، لكنه يشي بالفجوة بين شخصية محمد فراج ونيلي كريم في خط علاقتهما الدرامي، فتشعر بنوع من عدم الترابط أو التجانس.
تظهر نيللي كريم في دور صحفية تبحث وتتقصى عن فريق المكفوفين الذي يدربه بيومي فؤاد، ويحاول محمد فراج حارس الأمن الذي يعاني من أوضاع مادية سيئة الانضمام إليه للمشاركة في بطولة دولية تقام في بولندا؛ مشاركته في البطولة الدولية ستتيح له الحصول على الفيزا، وبالتالي سيتحقق له حلم الهجرة. نيللي هنا هي شخصية محمود شوقي الصحفي الذي تقصى عن هذه الحادثة عام 2016، وكتب عنها وظهر في حوارات تلفزيونية ربَّما أشهرها مع شوبير الذي علق في برنامجه أن شوقي هو صاحب السبق الصحفي والتحريات التي كشفت هذه الفضيحة.
الفيلم يقدم سينما مختلفة عن السينما الحالية، سينما تذكرنا بسينما الثمانينيات، حيث صوت الشارع وهمومه هي الطاغية في الفيلم، وهو نقيض التوجه الحالي.
خلق حكاية درامية من خبر صحفي هو أمر طبيعي، فالسينما هي محاولة لعرض وفهم الحياة على الشاشة، لكن ما حصل مع فيلم «فوي! فوي! فوي!» هو نسخ ونقل التحقيقات من الأوراق إلى الشاشة؛ لذلك ظهرت بعض الخطوط الدرامية والمشاهد بشكل ضعيف. فمثلاً علاقة محمد فراج بنيلي كريم تبدو غير مقنعة بالنسبة لتصاعد الأحداث، وأيضًا علاقته ببسنت شوقي، وتبدو هذه العلاقة أُقحمت على النص بشكل فج، وكذلك المشهد الذي نرى فيه صديقه يقوم بتوصيل طلب إلى زبون في شقة مفروشة ويصادف بذات الشقة حبيبته السابقة، مشهد لا يؤثر في السياق الدرامي ومفتعل.
هذه العلاقات التي لم تتناولها التحقيقات الصحفية وحاول المخرج/ السيناريست من خلالها بناء شخصياته بشكل درامي، كانت نقطة ضعف في السرد، وعدسة عمر تبدو أجمل من قلمه في تجربته الأولى.
السيناريست هو حكاء فوتوغرافي، وكلما تمكن من أدواته الفنية أتاح للحكاية الدرامية أن تظهر بشكل مكتمل وناضج، ومثال ذلك الفيلم السينمائي «بين السماء والأرض» الذي أخرجه صلاح أبو سيف عام 1959 لفكرة التقطها نجيب محفوظ من خبر صحفي عن تعطل مصعد في إحدى العمارات، فقام نجيب بتكوين الفكرة الأساسية للفيلم وطورها مع صلاح والسيد بدير للفيلم الذي يعتبر من كلاسيكيات السينما المصرية.
تطرق السينما المصرية فكرة الهجرة على استحياء، فتبدو الهجرة أو حالة الاغتراب في بعض الأفلام كإكسسوار للبطل أو حدث عابر ضمن السياق الدرامي، مثال ذلك فيلم «الباب المفتوح»، وربَّما رمزية للمستوى الاجتماعي. أمَّا انعكاس الغربة على الفرد والعائلة والمجتمع وأسبابها والمشاكل الناتجة عنها، فكان تناول السينما المصرية لها محدودًا ولا يتناسب مع أعداد المغتربين خارج مصر، وقد صرحت وزيرة الهجرة المصرية أن العدد يقارب 12 مليون مصري يعيش خارج مصر.
تناول السيناريست مدحت العدل فكرة الهجرة في التسعينيات من خلال فيلم «أميركا شيكا بيكا» و«همام في أمستردام»، وكانت الفكرة واحدة والمعالجة مختلفة.
في عام 1993 قدم العدل مع المخرج خيري بشارة قصة مجموعة من المصريين يحاولون الحصول على الفيزا الأميركية من خلال السمسار جابر «سامي العدل» في عاصمة رومانيا، إلا أن تجربتهم تشكل رحلة فشل على عدة صُعُد: علاقات اجتماعية وعلاقة مع الجنس الآخر. تمثل أميركا في الفيلم الحرية والحلم وصناعة النجاح والأساطير مثل مايكل جاكسون، حتى بالنسبة للفتاة الرومانية التي تعرف عليها منسي «محمد فؤاد» ؛ لهذا كانت فكرة الرحيل سويًا إلى أميركا هي الرابط بينهم، وبمرور الأحداث نكتشف أن هذا الرابط هش ولا يحتمل الحياة الحقيقية.
رمزية اختيار الاسم، فالبطل منسي كبقية المهمشين في المجتمع. حلم الهجرة يجمع أشخاصًا من مستويات مختلفة وأعمارًا متفاوتة وأسبابًا مختلفة للهجرة.
أميركا هي صورة النجاح، وفي بداية التسعينيات كانت أميركا هي القوة التي لا تقهر بعد حرب الخليج الثانية. كان دور السمسار جابر هو الصوت الناقد الغاضب على حال البلد والشعب من خلال السخرية وهي امتياز مصري، فحس الدعابة والسخرية لدى المصريين عالٍ. الفيلم في اعتقادي هو نظرة ذاتية للداخل أكثر منها انبهارًا بالخارج أو الآخر. ومن المفارقات أنه قبل صدور الفيلم وفي بداية العام خسرت مصر فرصة التأهل لكأس العالم عام 1994. بطريقة درامية، يقرر أبطال العمل العودة لمصر بعد دفن رفيقهم الذي هو بمثابة الأب لهم في رومانيا، وهذه بنظري رمزية عن دفن الحلم ومحاولة التعايش بعد الصدمة.
وفي نهاية التسعينيات قدم مدحت العدل مع المخرج سعيد حامد فيلم «همام في أمستردام»، بداية الفيلم تحمل صوت الست أم كلثوم وهي تغني «يا ليلة العيد انستينا». هذه الافتتاحية تنويه عن بداية الأيام الجميلة والفرح، ورغم بعض المتاعب التي يتعرض لها همام، فإنه ينجح في تجربه الغربة ويحقق أحلامه وأحلام أهله، فكل الصعوبات ما هي إلا منعطفات قبل الوصول للقمة.
ومثلما كان منسي تلميحة عن نهاية الرحلة، فإن اختيار اسم همام هو رمزية للشجاعة والعزيمة والهمة.
همام أيضًا انعكاس للنظرة نحو الذات والشعور بالاعتزاز والثقة، فالبطل يحمل إرثًا يفخر به فهو ابن لشهيد، وهذه الصورة حاضرة في أكثر من مشهد. ومن الجدير بالذكر أن الفيلم صدر في بداية عام 1999، وفي السنة السابقة لصدور الفيلم فازت مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
يبدو همام كاعتذار تقدمه السينما عن تجربة الاغتراب الفاشل، وأن هناك ضوءًا في نهاية النفق. ومع هذا التباين في المعالجة، فإن نقاط التقاطع بين الفيلمين عديدة، فمثلاً الفشل أو النجاح هو تجربة لا تقبل التجزئة، فنجاح همام في تحقيق أحلامه يرافقه نجاحه في علاقته مع المرأة، ونقيض ذلك في «أميركا شيكا بيكا». أيضًا نجد أن الفيلمين يحرصان على إبراز التنوع الديني «مسلم/ قبطي»، ويكون اكتشاف البطل المسلم لزميله القبطي عن طريق الصدفة! ويحرص مدحت في الفيلمين على إبراز وحضور قيمة الصداقة في السياق الدرامي. ومن المفارقات أن جملة مثل «تغطية الصدر بالجرائد» حاضرة، وهذه ممارسة مغرقة في محليتها وكأنها رمزية عن صعوبة الانفصال عن الجذور بالنسبة للشخصية المصرية، فالعودة ليست لمياه النيل فقط، هي عودة لكل الطقوس.
تقدم زينب عزيز حكاية مجموعة شباب ينتمون إلى قرية من قرى مصر يقررون الهجرة الى إيطاليا، وتأخذنا عدسة المخرج علي إدريس في هذه الرحلة بين تراب القرية وأمواج المتوسط في فيلم «البر الثاني». هذا الفيلم لم يحظَ بانتشار واسع، وهو يليق بالإهداء الذي قررت أسرة الفيلم منحه لسينما محمد خان، فهو فيلم الأحلام غير المكتملة والإحباطات.
هناك شعور خفي بالتشابه في الجو العام بين الفيلم وفيلم «الطوق والأسورة» رغم اختلاف الموضوع وعدم وجود نقاط تقاطع. وبعد محاولات عدة للوصول للتشابه وجدت أن السبب في ذلك هو شعور أب الأسرة بالعجز، عزت العلايلي «بخيت البشاري» مشلول، و«أبو سعيد» عبدالعزيز مخيون أعمى، بالإضافة إلى الفقر.
هذا التجاهل لفكرة المنفى والغربة لا يقتصر على السينما حتى في الأدب، فالإنتاج الأدبي المصري الذي يتناول مواضيع الاغتراب والهجرة محدود، ولا يقارن بالإنتاج اللبناني والفلسطيني، أو حتى دول شمال إفريقيا كالمغرب والجزائر.
وأعتقد أن من أبرز من تناول هذا الموضوع من الأدباء توفيق الحكيم، وطه حسين، وإبراهيم عبدالمجيد. المفارقة أن الأغاني المصرية تعبر عن هذه التجربة بسخاء أكثر، فلا يمكننا تجاهل أغنية نادية مصطفى «سلامات» التي شكلت ذاكرة جيل بأكمله، وأنغام «شنطة سفر»، و«يا مسافر وحدك» لمحمد عبدالوهاب، و«خلاص مسافر» لشادية، و«بكرة السفر» لأم كلثوم، و«على الله تعود» لفريد الأطرش.
يبدو أن الشعر الذي يعبر عن نفسه من خلال الأغنية أكثر تحررًا في التعبير عن الغربة كتجربة إنسانية عميقة، مقارنة ببقية الفنون في الفضاء الفني والثقافي المصري.
المصدر: سوليوود