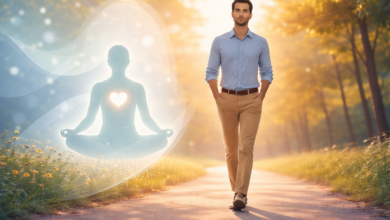الجسور التي تُبنى لا تُهدم
الجسور التي تُبنى لا تُهدم
هلا خباز
يُلازمني الأرق منذ مدة طويلة، أمضي ليلي أتجول بين المنصات كعادة سيئة تزيد من أرقي ولم أستطع التخلي عنها. وخلافًا للمحتوى السائد في أغلب المنصات، لامس قلبي حوارًا للعظيم خالد تاجا في مسلسل “الفصول الأربعة” يُخاطب به القديرة نبيلة النابلسي: “بدك شي؟ لازمك شي؟ أنتِ ما بتطلبي أنتِ بتآمري أمر”. ردت عليه وقالت: “أنا بدي ياك أنت، بدي ياك جنبي، حولي وحوالي”.
على بساطة المشهد، عبّر عن هاجس لطالما أرّقني، ففي كل محتوى ومنصة ومع كل نصيحة من الأهل والأصدقاء، يوجد تكريس لنشر ثقافة التخلي والاستقلال التام عن الشريك، وعن رسم الحدود والمسافات بين الأحباب. هناك دورات مكثفة في كبت المشاعر وبرودة الإحساس، ونشر للنصائح على شاكلة “انشغل بحياتك”، “لا تتصل”، “لا ترسل”، “لا تسأل”، و”خليه هو اللي يبادر”، ومئة “لا” و”لا”. ورغم أن الكلام يبدو منطقيًا جدًا نظرًا لما نرى ونسمع، لكنه بكل أسف هو دعوة صريحة للتخلي.
في السنوات الأخيرة، إذا فتحت أية منصة تواصل اجتماعي، ستجد أن أغلب العناوين تدور حول: التخلي، الانسحاب، وضع الحدود، وقطع العلاقات السامة. بينما أصبح الحديث عن كسب المودة، والتعبير عن المحبة، وبناء الجسور، وتقوية الروابط، نادرًا. فما السبب وراء هذا التحول؟
جيل اليوم أصبح أكثر وعيًا بمفهوم “الصحة النفسية”، وأكثر إدراكًا بأن الاستمرار في علاقات مرهقة أو مؤذية قد يكون مدمّرًا على المدى البعيد، وبأن تضحية الأمهات لم تعد صالحة لهذا الزمان. لذلك، أصبح الخطاب العام يركّز على حماية الذات، وبأن التخلي خطوة شجاعة رُفع شعارها في كل مكان: “اعتزل ما يؤذيك”.
على ما يبدو أنهم تبنوا رأي فرانز كافكا حينما قال: “حتى لو اقتضى الأمر أن تخلع قلبك وتمضي من دونه، المهم ألا تبقى مرهونًا بالمشاعر التي تمرر لجوفك القلق والأذى وتبقيك بائسًا”.
أو لعله الخوف من أن تلتصق بمجتمعاتنا تهمة التساهل مع الأذى، جعلنا نفرط في نشر قواعد لا فائدة منها سوى تأصيل الجفاء بين الناس، وبأن الأقوى والأكثر تأثيرًا هو من يمارس ويتباهى بالتخلي دون أن يهتز له رمش.
للكاتب والروائي المصري أنيس منصور عبارة جميلة قال فيها: “من السهل أن تقول: انتهى الأمر، لكن الأصعب أن تبذل جهدًا لترى إن كان يستحق أن يستمر”.
لماذا لا نزرع فن التمسك والتعبير عن المشاعر؟ لماذا لا نعلمهم أن العشرة تستحق أن نحافظ عليها؟ وأن الصفات الجميلة في الشريك ممكن أن تجعلنا نغض البصر عن هفوات صغيرة لا تمس الكرامة ولا تسبب الأذى؟
نحن هنا نؤكد مقولة نيلسون مانديلا: “التسامح لا يعني نسيان الإساءة، بل يعني أن نقرر أن مستقبلنا أثمن من أن نحمله ثقل الماضي”.
لماذا لم نعد نسمع عبارة “البادئ أكرم، البادئ ألطف وأحن”؟ نحن هنا لا نقصد الدفاع أو الحديث عن العلاقات السامة والمؤذية أياً كان نوعها، حديثنا وتساؤلنا عن علاقاتنا الإنسانية التي تشوبها الشوائب من فترة إلى أخرى، العلاقات التي يمتلك كل شخص فيها آراء وقيمًا وطرق تعبير مختلفة عن الآخر، عن الحياة التي تُصاب بفترات من الملل والفتور، عن الحياة التي تتأثر بالمحيط الخارجي والظروف.
“إن السعي وراء الحب يغيّرنا، فما من أحد يسعى وراء الحب إلا وينضج أثناء رحلته. فما إن تبدأ رحلة البحث عن الحب، حتى تبدأ تتغيّر من الداخل ومن الخارج” كما تقول إليف شافاق.
لمَ علينا أن نتغير؟ أن نتصرف خلافًا لطبيعتنا وخلافًا لأمزجتنا؟ لمَ علينا أن نتبنى نظرية الفريسة والصياد؟ أن نمارس الشد والجذب؟ لمَ علينا أن لا نكون نحن؟
محتوى مثل “اقطع العلاقة فورًا” أو “أنت لا تدين لأحد بالبقاء” ينتشر أسرع من النصائح التي تتطلب جهدًا وصبرًا. في زمن الحساسيات العالية، التحدث عن إعطاء فرصة ثانية أو محاولة كسب المودة قد يُفسَّر وكأنه تشجيع على البقاء في علاقات مؤذية، وهذا يجعل البعض يتجنب الخوض في هذا النوع من المحتوى.
ولكن المودة الحقيقية تُبنى على التعاطف، والإصغاء، والتفاهم، والرغبة الصادقة في إصلاح الشروخ. وهذا أمر أصعب من الضغط على زر “بلوك”. لذلك، يجد صانعو المحتوى أن التحدث عن التخلي أسهل وأكثر جاذبية من الدخول في تفاصيل صعبة حول من يستحق فرصًا ثانية.
لا شيء يمر بلا عقبات، ولا رحلة بلا مطبات، لذا قال جبران خليل جبران يومًا: “المحبة الحقيقية لا تُقاس بعدد الأيام الجميلة، بل بقدرتنا على المرور معًا عبر العواصف”.
أذكر أنه سألني يومًا: “لمَ أنتِ لطيفة إلى هذا الحد؟ ولمَ تحاولين دوماً أن تبادري وأن تكسبي رضاي؟”.. لعلها جيناتي المتوارثة من أمي، وبقايا لرواسب مجتمع لطالما رفضت عاداته، هكذا أجبت وصمت. ولسان حالي يردد ما قاله محمود درويش: “قلبي يرن من الجهتين، طريق الصواب وطريق الخطأ، لعلي أخطأت ولكنها التجربة”.
كثيرون منا تربوا على أفكار تمجّد الصبر المفرط وتحمل الأذى باسم الحب أو الواجب. اليوم، هناك رد فعل معاكس: رفض فكرة البقاء في علاقة مهما كانت الظروف، ما جعل فكرة التخلي تحمل معنى التحرر من إرث ثقافي ثقيل.
“أن تحب أحدهم ليس أن تجد فيه الكمال، بل أن ترى عيوبه وتختار أن تبقى” كما يقول فيكتور هوغو.
أو لعل خوفنا من الهجر هو ما يحولنا إلى كائنات هشة تستميت طلبًا للرضا والقبول، ولا يمكننا إنكار تأثير الكم الهائل من التجارب التي عشناهها أو سمعناها على تصرفاتنا وتعاطينا مع الآخر.
“لم يصافح خدّها قبل رحيله، بل غرسَ في وجهها جرحًا. شتلة الجرحِ أزهرت، أينعت، تدلّت قطوفها وثقلت غصونها وامتدت جذورها عميقًا.. عميقًا صوب الرّوح… ولم يرغب أحدٌ بقطف الفتاة التي تحولت إلى جرح”. حالة وصفتها الروائية الكويتية بثينة العيسى في “قيس وليلى والذئب”.
يا ترى كم ذئبًا ترك جرحًا يدمي قلبك؟
لكن الحقيقة أن البقاء ليس ضعفًا، بل هو بطولة من نوع آخر في كثير من الأحيان، بطولة أن ترى العيب وتحاول إصلاحه.
نحن نبقى لأن بيننا تاريخًا لا يُنسى، نبقى لأن حلاوة الأيام طغت على مرّها، نبقى لأن الأمل في أن يُقدَّر وأن يتغير مازال موجودًا، نبقى لأننا نراهن على قلبه وبأنه سيلين، ولأنه أبدى رغبة صادقة في التغيير لا اعترافًا يشبه القفز من مركب يغرق، نبقى لأن الاحترام بقي سيد الموقف في أحلك الليالي والظروف.
ربما آن الأوان لإعادة التوازن لعلاقتنا بالآخر، أن نُعلّم أنفسنا متى نتخلى، ومتى نحاول أن نكسب المودة. فالانسحاب ليس دائمًا بطولة، كما أن التمسك ليس دائمًا ضعفًا. فكما أن التخلي مهارة، المودة مهارة أعمق. حين يغيب الحديث عن إصلاح الروابط، نصبح مجتمعًا يعرف كيف يقطع الجسور أكثر مما يعرف كيف يبنيها. المودة ليست ضعفًا، بل قدرة على تجاوز الخلافات وفهم الآخر، وهي مهارة تضمن علاقات إنسانية أكثر دفئًا وأقل عزلة.
المصدر: صحيفة البلاد