إحباط
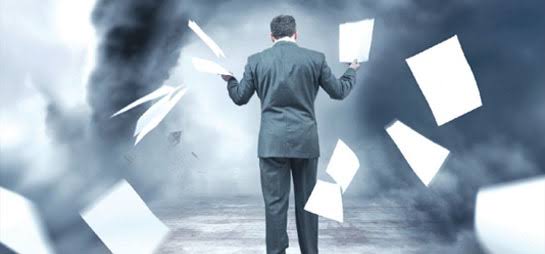
إحباط
عمر غازي
في أحد الفصول الدراسية بجامعة تورنتو عام 2017، أجرى فريق من الباحثين تجربة نفسية على مجموعة من الطلاب، طُلب من بعضهم حل مسائل رياضية معقدة وسط تشجيع مستمر، وطُلب من البعض الآخر نفس المهام وسط تعليقات سلبية محبطة، النتيجة كانت أن المجموعة الثانية سجلت تراجعًا بنسبة 52% في الأداء، رغم أن قدراتهم المعرفية متقاربة. كأن الكلمات وحدها كانت كفيلة بتعطيل العقول.
الإحباط لا يأتي دائمًا من الفشل، بل أحيانًا من كثرة المحاولة، من الشعور بأنك تبذل أكثر مما تحصل، وأنك تتكئ على جدار ينهار كلما اقتربت من الوقوف. هو ذلك الشعور الصامت الذي لا يصرخ، لكنه يأكل من الداخل، مثل صدأٍ خفيف لا يُرى، لكنه يأكل المعدن مع الوقت.
في دراسة نشرتها جامعة هارفارد عام 2020، تبيّن أن 67% من البالغين يعانون من نوبات إحباط متكررة لا ترتبط بأحداث كبيرة، بل بتراكم التفاصيل الصغيرة التي لا تُرى. رسالة لم تُرد، اجتماع لم يُدعَ إليه، وظيفة لم يُقبل فيها، أحلام مؤجلة، ووعود مؤجلة أكثر.
الإحباط لا يقتلك دفعة واحدة، بل يضعفك على مهل، يُربك تركيزك، يثقل حركتك، يُشوّه نظرتك للعالم وللذات. والأسوأ أنه يجعل الخطوة القادمة تبدو بلا جدوى، كأنك تمشي، لكنك لا تقترب، وتتنفس، لكنك لا تحيا.
لكن، هل يمكن مقاومته؟ هل يمكن ترميم الداخل حين يتشقق بصمت؟ بعض الدراسات تقول نعم، بشرط أن نتعامل مع الإحباط كما نتعامل مع الكسر: نراه، لا ننكره. نرفق به، لا نُعنّفه. نمهله، لكنه لا يُمهلنا.
في بحث أجرته جامعة كاليفورنيا عام 2019، وُجد أن كتابة المشاعر السلبية لمدة 15 دقيقة يوميًا ساعدت المشاركين على تقليل مستويات التوتر بنسبة 35% خلال أسبوعين. وكأن البوح وحده علاج، وكأن الإحباط لا يحتمل الصمت الطويل.
السؤال الذي لا يجيب عليه أحد: هل نُشفى من الإحباط حقًا، أم أننا فقط نؤجله إلى إشعار آخر؟ وهل يكفي أن نتظاهر بالثبات كي لا ننهار، أم أن الثبات الحقيقي يبدأ حين نعترف بأننا على وشك الانكسار؟




