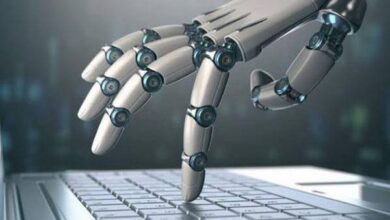الذكاء الصناعى والنصب الإنسانى

عمرو الزنط
الأبحاث العلمية عادة ما تترجم في أوراق بحثية ترسل إلى مجلات ودوريات محكمة. وكل باحث أكاديمى صادفه في مرحلة ما من حياته العلمية أحد المحكمين الذي لا يقنعه شكل ومضمون البحث المقدم، فيكتب تقريرا مختصرا شديد السلبية. وهناك أنماط معروفة، أحدها يأتى كالآتى: «كل ما هو صحيح في هذا الطرح معروف، أما ما هو جديد فيه فليس صحيحا».. وهذا رأيى بالضبط في كتابات من يلقبون بمفكرى «ما بعد الحداثة»، رغم أنهم يأتون أحيانا بتفسيرات متطرفة لأفكار معروفة فيبرزون أهميتها ومدى نطاق صلاحيتها.
من بين هذه التأويلات عبارة مشهورة رددها الفرنسى جاك ديريدا: «ليس هناك ما هو خارج النص».. كالعادة مع هذا النوع من المفكرين، من الصعب فهم ما كان يعنيه بالضبط، لأنه طالما ردد عبارات مبهمة عن قصد، لزوم الإيحاء بالعمق الفكرى. لكنى أعتقد أن مجمل فكره عن اللغة يمكن تلخيصه هكذا: النصوص المكتوبة ترجع في معناها إلى بعضها البعض، وليس إلى الواقع الذي يعيشه الإنسان مباشرة؛ لأن الكلمات تكتسب معناها من خلال السياقات التي تأتى فيها في النصوص.. لا الكلمات ولا النصوص لها معنى مطلق إذن.
كما قلت، ما يقوله هؤلاء من كلام صحيح ليس عادة جديدا.. وليس هناك الكثير من الجديد في كلام «ديريدا» المذكور، لأنه سبقه لمثله الفيلسوف لودفيك فيتجنشتاين في نهاية حياته، بعد عمر قضاه في صراع مع الموضوع.. حين لاحظ أن لا معنى للكلمات خارج أنماط استخداماتها اجتماعيا، فمجمل هذه الاستخدامات هو ما يحدد معناها، وليس شىء مجرد وثابت تشير إليه.. مع ملاحظة هنا الفرق المهم بين «اجتماعيا» و«لا شىء خارج النص».
نعود إلى النص.. لا شك أن كل قارئ يعرف أنه إذا أراد معرفة الهدف من استخدام كلمة لم يقابلها من قبل في نص ما، يمكنه التدقيق في الفقرة التي أتت فيها. وأنه إذا قابلها مرات متكررة في سياقات مختلفة سيتمكن من إدراك أنماط استخدامها، حتى دون أن تكون لديه تجربة مباشره مع ما تمثله في الواقع، ودون أن يستطيع بالضرورة تخيل شكل ما تشير إليه (إذا كانت ترمز لأشياء كظواهر طبيعية أو أماكن على الأرض مثلا).. هكذا يمكن أن يبدأ مباشرة في استخدامها، وتكوين جمل مفيدة منها، وكأنها رمز رياضى، تربطه منطقيا المعادلات المجردة برموز أخرى.
هكذا بالفعل تعمل آلات اللغة الأكثر انتشارا حاليا في مجال ما يسمى بالـ «ذكاء الصناعى».. نحن نبدأ «الحديث» معها بسؤالها عن موضوع ما، فتبحث في ملايين المصادر عن الكلمات التي وردت في السؤال، وتفحص إحصائيا في كيفية ظهور هذه الكلمات في سياق النصوص التي ابتكرها البشر.. ثم تبدأ في الرد، وبعد كل كلمة تحررها تبحث في المصادر عن احتماليات وجود الكلمة التالية من بين عدد مهول من الكلمات المحتملة.
هكذا تقوم بترتيب الكلمات متوالية (مع إضافة عنصر عشوائى، لتفادى تكرار نفس الكلمات كثيرا والحد من الركاكة).. وهكذا تستخلص الآلة «ردا صناعيا»، مصطنعا لكن مفيد، باستخدام عدد كبير من المصادر النصية الإنسانية التي ترجع إليها.
ولأن الرد يمكن أن يخدع البشر أحيانا، يعتقد البعض أنه يمثل «ذكاء». لكنه ذكاء فعلا فقط إذا كان كلام ديريدا صحيحا حتى النهاية؛ أي أنه لا يوجد فعلا شىء «خارج النص».. لكن هناك بالطبع أشياء خارج النص؛ هناك عالم طبيعى تحدده معطيات الواقع ويدركه الإنسان.. ولذلك، رغم أنه يمكن للإنسان تعلم كيفية استخدام الكلمات مع تكرار سياقها في النصوص المختلفة، دون الحاجة إلى تخيل ما تشير إليه في الواقع.
فمعظم البشر سيحركهم إحساس داخلى نحو محاولة التخيل. وهذا هو ما يجسد الذكاء الحقيقى، ويدفع تطور «أشكال الحياة» والمجتمعات اللغوية (حسب تعبير فيتجنشتاين).. هذا الذكاء ينعكس كذلك في القدرة على التجديد في الأسلوب الأدبى والإنتاج الفكرى والمعرفى، الذي يأتى بمفاهيم ومعان جديدة تدفع الإبداع في اللغة والأدب، وفى الفن والعلم بصفة عامة.
الجديد في تأويل ديريدا «المتطرف» لأفكار أمثال فيتجنشتاين خاطئ إذن. فهناك الكثير جدا مما هو خارج النص في عالم الإنسان، مما يفصل فكر البشر عن آلات اللغة الحالية.. مع ذلك، هناك نوع من «البنى آدمين» يتكلم فعلا وكأنه آلة تردد شعارات، لأنه فاقد للخيال ومتجاهل لمعطيات الواقع؛ ورد فعله، عند توجيه السؤال إليه، مؤسس على اصطياد بعض الكلمات الدالة، ثم بلورة جواب نمطى مكون من مفردات تبدو رنانة.
يرتبها ويربطها ببعضها حسب ما عرفه من استخدامات لها في مستودع من العبارات الدارجة.. أعتقد أن هذا هو «ذكاء» شخصيات سياسية مثل دونالد ترامب، والكثير ممن يعملون في مجالات الدعاية المخادعة الرخيصة، وكذلك أمثال الأستاذة الـ «جرافيك ديزاينر» التي «اقتبست» رسومات الفنان الروسى.
فهل هؤلاء «روبوتات تشات» بالفعل؟، وهل انتشارهم وتزايد تأثيرهم في عصر التواصل يجسد خطرا أكبر بكثير من أي «ذكاء صناعى» مدمر، من النوع الذي أصبح من دواعى الـ «تريند» التلويح تكرارا بأنه يداهم الإنسانية؟.